|
|
|
|
|
|
| المستشار نبيل جلهوم | ||
| المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
| دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
| الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
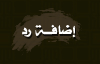 |
| انشر الموضوع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
الأخت / الملكة نور الأربعين النووية - الحديث التاسع ( الأَخذُ باليَسير وَ تَركُ التَعْسِير الطاعة و عدم التعنت سبيل النجاة ) أهمية الحديث سبب الورود مفردات الحديث المعنى العام 1 - الضرورات تبيح المحظورات 2 - المشقة تجلب التيسير 3 - التشديد في اجتناب المنهيات 4 - من أسباب هلاك الأمم 5 - السؤال وحكمه 6 - التحذير من الاختلاف و الحثّ على الوحدة و الاتفاق عن أبي هُرَيْرةَ عَبْدِ الرَّحمنِ بنِ صَخْرٍ رضي الله عنه قال : سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ( ما نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجتَنبوهُ ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، فإنَّما أَهْلَكَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ واخْتلاُفُهُمْ على أَنْبِيَائِهِمْ ) رَواهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ أهمية الحديث : إن هذا الحديث ذو أهمية بالغة وفوائد جلى ، تجعله جديراً بالحفظ والبحث : وهو من قواعد الإسلام المهمة ، ومن جوامع الكَلِم التي أعطيها صلى الله عليه وسلم ، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام . وهو حديث عظيم من قواعد الدين وأركان الإسلام ، فينبغي حفظه والاعتناء به . سبب الورود : سبب ورود هذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( أيها الناسُ ! قد فرض اللهُ عليكم الحجَّ فحجُّوا . فقال رجلٌ : أكل عامٍ ؟ يا رسولَ اللهِ ! فسكت . حتى قالها ثلاثًا . فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لو قلتُ : نعم . لوجبت . ولما استطعتم . ثم قال ذروني ما تركتُكم . فإنما هلك من كان قبلكم بكثرةِ سؤالِهِم واختلافِهِم على أنبيائِهم . فإذا أمرتُكم بشيٍء فأتوا منهُ ما استطعتم . وإذا نهيتُكم عن شيٍء فدعوهُ . إنَّ اللهَ أذِنَ لرسولِه ولم يأذن لكم . وإنما أَذِنَ لي فيها لم يفسق .) الراوي : أبوهريرة – المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم – الصفحة أو الرقم : 1337 خلاصة حكم المحدث : صحيح وورد أن السائل هو الأقرع بن حابس رضي الله عنه . مفردات الحديث : نهيتكم عنه طلبت منكم الكَفَّ عن فعله ، والنهي : المَنْع فاجتنبوه أي اتركوه فأتوا فافعلوا ما استطعتم ما قدرتم عليه وتيسر لكم فعله دون كبير مشقة أهلك صار سبب الهلاك كثرة مسائلهم أسئلتهم الكثيرة، لا سيما فيما لا حاجة إليه ولا ضرورة . المعنى العام : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه : لقد ورد النهي في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعان عدة ، والمراد به هنا التحريم والكراهة : نهي التحريم : من أمثلة ذلك : النهي عن الزنا وشرب الخمر وأكل الربا والسرقة وقتل النفس بغير حق . فمثل هذه المنهيات يجب اجتنابها دفعة واحدة ، ولا يجوز للمُكَلَّف فعل شيء منها ، إلا إذا ألجأته إلى ذلك ضرورة ، بقيود وشروط بيّنها شرع الله تعالى المحكم . نهي الكراهة : ومن أمثلة ذلك : النهي عن أكل البصل أو الثوم النِّيْئ ، لمن أراد حضور صلاة الجمعة أو الجماعة . فمثل هذه المنهيات يجوز فعلها ، سواء دعت إلى ذلك ضرورة أم لا ، وإن كان الأليق بحال المسلم التقي اجتنابها ، ما استطاع إلى ذلك سبيلاً . الضرورات تبيح المحظورات : قد يقع المسلم في ظروف تضطره إلى فعل المحرم ، وتلجئه إلى إتيان المحظور، وإن هو امتنع عن ذلك ألقى بنفسه إلى التهلكة. وهنا نجد شرع الله تعالى الحكيم ، يخفف عن العباد ، ويبيح لهم في هذه الحالة فعل ما كان محظوراً في الأحوال العادية ، ويرفع عنهم المؤاخذه والإثم . قال الله تعالى : } فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ { [ البقرة : 173 ] ومن أمثلة ذلك : إباحة أكل الميتة لمن فقد الطعام ولم يقدر على غيرها ، ولكن مما ينبغي التنبيه إليه ، هو ما يقع فيه الكثير من الناس ، عندما يأخذون هذه القاعدة على إطلاقها ، دون تحديد لمعنى الضرورة ، وحتى لا يقع المكلفون في هذا الخطأ ، نجد الفقهاء حدَّدوا معنى الضرورة : بما يجعل الإنسان في خطر يهدده بالموت ، أو بإتلاف عضو من أعضائه ، أو زيادة مرض ، ونحو ذلك مما يتعذر معه قيام مصالح الحياة ، أو يجعلها في مشقة وعسر لا يُحتمل . وفي الوقت نفسه حدّدوا مدى الإباحة بما يندفع به الخطر ، ويزول به الاضطرار ، فوضعوا هذه القاعدة : (الضرورة تُقَدَّرُ بَقْدرِها) . أخذاً من قوله تعالى : } غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ{ أي غير قاصد للمخالفة والمعصية ، وغير متعد حدود ما يدفع عنه الاضطرار . فمن اضطر لأكل الميتة ليس له أن يمتلئ منها أو يدخر ، ومن اضطر أن يسرق لِيُطْعِم عياله ليس له أن يأخذ ما يزيد عن حاجة يوم وليلة ، وليس من الاضطرار في شيء التوسع في الدنيا ، وتحصيل الكماليات ، فمن كان ذا رأسمال قليل ليس مضطراً للتعامل بالربا ليوسع تجارته . ومن كان له علاقات مع الناس ، ليس مضطراً لأن يجلس معهم على موائد الخمر ويسكت عن منكرهم . ومن كانت ذات زوج متهاون ، ليست مضطرة لأن تخلع لباس الحشمة وجلباب الحياء ، فتترك الآداب الشرعية ولباس المؤمنات ، لتحصل على إعجابه ورضاه .
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
المشقة تجلب التيسير: من المعلوم أن شرع الله عز وجل يهدف إلى تحقيق السعادة المطلقة للإنسان ، في كلٍّ مِن دنياه وآخرته ، ولذلك جاء بالتيسير على العباد ورفع الحرج عنهم . قال الله تعالى : } يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ} [ البقرة : 185] وقال : } وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ { [ الحج : 78 ] وقال صلى الله عليه وسلم : ( يَسِّرُوا ولا تُعَسِّرُوا ، وبَشِّرُوا ولا تُنَفِّرُوا ، وتَطَاوَعَا ولا تَخْتَلِفا ) الراوي : أبو موسى الأشعري عبدالله بن قيس – المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم : 8087 خلاصة حكم المحدث : صحيح حدود المشقة التي تستدعي التيسير : فهناك نوع من المشقة ملازم للتكاليف الشرعية ، لا تنفك عنه في حال من أحوالها ، لأنه من طبيعة التكليف ، فمثل هذا النوع من المشقة لا أثر له في إسقاط الواجبات أو تخفيفها . فليس لأحد أن يُفْطر في رمضان لشعوره بشدة الجوع ، كما أنه ليس لأحد قَدَرَ على نفقات الحج ، وهو صحيح البدن ، أن لا يحج ، لما في الحج من مشقة السفر والبعد عن الأهل والوطن !! وهناك نوع من مشقة ليس من طبيعة التكليف ، ويمكن أن تنفك عنه الواجبات في كثير من أحوالها ، بل هو من الأمور الطارئة والعارضة ، والزائدة عن القدر الذي تقتضيه التكاليف في الظروف العادية ، وهذا النوع من المشقة على مرتين : المرتبة الأولى : توقع المكلف في عسر وضيق خفيفين ، كالسفر القصير والمرض الخفيف وفوات المنافع المادية ، فمثل هذه المشقة لا أثر لها أيضاً في التزام الواجبات . المرتبة الثانية : مشقة زائدة ، تهدد المكلف بخطر في نفسه أو ماله أو عرضه ، كمن قدر على الحج مثلاً ، وعلم أن في الطريق قطاع طرق ، أو خاف من إنسان يترقب غيابه ليسرق ماله أو يعتدي على أهله ، ونحو ذلك ، مما يعتبر حرجاً وضيقاً ، في عرف ذوي العقل والدين. فمثل هذه المشقة هي المعتبرة شرعاً ، وهي التي تؤثر في التكاليف، وتوجب الإسقاط أحياناً أو التخفيف . التشديد في اجتناب المنهيات واستئصال جذور الفساد : يسعى شرع الله عز وجل دائماً للحيلولة دون وقوع الشر ، أو بزوغ بذور الفساد ، ولذا نجد الاهتمام بأمر المنهيات ربما كان أبلغ من الاهتمام بالمأمورات ، ولا يعني ذلك التساهل بالمأمورات ، وإنما التشديد في اجتناب المنهيات عامة ، والمحرمات على وجه الخصوص ، لأن نهي الشارع الحكيم لم يَرِد إلا لما في المنهي عنه من فساد أكيد وضرر محتم ، ولذا لم يُعْذَر أحد بارتكاب شيء من المحرمات ، إلا حال الضرورة الملجِئة والحاجة المُلِحَّة ، على ما قد علمت . ومن هنا يتبين خطأ مسلك الكثير من المسلمين ، لا سيما في هذه الأزمنة، التي شاع فيها التناقض في حياة الناس ، عندما تجدهم يحرصون على فعل الطاعة والواجب ، وربما تشددوا في التزام المندوب والمستحب ، بينما تجدهم يتساهلون في المنهيات ، وربما قارفوا الكثير من المحرمات ، فنجد الصائم يتعامل بالربا ، والحاجّة المزكية تخرج سافرة متبرجة ، متعذرين بمسايرة الزمن وموافقة الركب . وهذا خلاف ما تقرر في شرع الله الحكيم ، من أن أصل العبادة اجتناب ما حرم الله عز وجل ، وطريق النجاة مجاهدة النفس والهوى ، وحملها على ترك المنهيات ، وأن ثواب ذلك يفوق الكثير من ثواب فعل الواجبات . فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( اتَّقِ المحارمَ تَكن أعبدَ النَّاسِ ) صحيح الترمذي وهذه عائشة رضي الله عنها تقول : من سَّره أن يَسبِقَ الدائب المجتهد فليَكُفّ عن الذنوب . وهذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يُسأل عن قوم يشتهون المعصية ولا يعملون بها ، فيقول : أولئك قوم امتحن الله قلوبهم للتقوى ، لهم مغفرة وأجر عظيم . وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك ، ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله ، فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير . من أسباب هلاك الأمم : لقد بين الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ، أن من أسباب هلاك الأمم وشق عصاها وتلاشي قوتها واستحقاقها عذاب الاستئصال - أحياناً – أمرين اثنين هما : - كثرة السؤال والتكلف فيه ، - والاختلاف في الأمور وعدم التزام شرع الله عز وجل . لقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عامة أن يكثروا عليه من الأسئلة ، خشية أن يكون ذلك سبباً في إثقالهم بالتكاليف ، وسداً لباب التنَطُّع والتكلف والاشتغال بما لا يعني ، والسؤال عما لا نفع فيه إن لم تكن مضرة . روى البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال . قال صلى الله عليه و سلم : ( إنَّ اللَّهَ حرَّمَ عليكم عقوقَ الأمَّهاتِ ، ومنعًا وَهاتِ ، ووأدَ البناتِ وَكرِه لَكم : قيلَ وقالَ ، وَكثرةَ السُّؤالِ ، وإضاعةَ المالِ ) الراوي : المغيرة بن شعبة – المحدث : البخاري – المصدر : صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم : 5975 خلاصة حكم المحدث : [ صحيح ] |
|
#3
|
|||
|
|||
|
السؤال وحكمه : إن السؤال على أنواع : مطلوب ومنهيٌّ عنه : أ- أما المطلوب شرعاً ، فهو على درجات : فرض عين على كل مسلم : بمعنى أنه لا يجوز لمسلم تركه والسكوت عنه ، وهو السؤال عما يجهله من أمور الدين وأحكام الشرع ، مما يجب عليه فعله ويطالَب بأدائه ، كأحكام الطهارة والصلاة إذا بلغ ، وأحكام الصوم إذا أدرك رمضان وكان صحيحاً مقيماً ، وأحكام الزكاة والحج إذا ملك المال أو كان لديه استطاعة ، وأحكام البيع والشراء والمعاملات إذا كان يعمل بالتجارة ، وأحكام الزواج وما يتعلق به لمن أراد الزواج ، ونحو ذلك مما يسأل عنه المكلف . وفي هذا يقول الله تعالى : } فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون َ { [ النحل : 43 ] وعليه حمل ما رواه البيهقي في " شعب الإيمان " ، من قوله صلى الله عليه وسلم : ( طلبُ العلمِ فريضةٌ على كلِّ مسلمٍ ، و إنَّ طالبَ العلمِ يستغفرُ لهُ كلُّ شيءٍ ، حتى الحيتانُ في البحرِ ) الراوي : أنس بن مالك - المحدث : السيوطي – المصدر : الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم : 5266 خلاصة حكم المحدث : صحيح فرض كفاية : بمعنى أنه لا يجب على كل مسلم ، بل يكفي أن يقوم به بعضهم ، وهو السؤال للتوسع في الفقه بالدين ، ومعرفة أحكام الشرع وما يتعلق بها ، لا للعمل وحده ، بل ليكون هناك حَفَظَة لدين الله عز وجل ، يقومون بالفتوى والقضاء ، ويحملون لواء الدعوة إلى الله تعالى . وفي هذا يقول الله تعالى : } وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ { [ التوبة : 122 ] مندوب : معنى أنه يستحب للمسلم أن يسأل عنه ، وذلك مثل السؤال عن أعمال البِرِّ والقربات الزائدة عن الفرائض . ب- سؤال منهي عنه ، وهو على درجات أيضاً : حرام : أي يأثم المكلف به ، ومن ذلك : - السؤال عما أخفاه الله تعالى عن عباده ولم يُطلعهم عليه ، وأخبر أن علمه خاص به سبحانه ، كالسؤال عن وقت قيام الساعة ، وعن حقيقة الروح وماهيتها ، وعن سر القضاء والقدر ، ونحو ذلك. - السؤال على وجه العبث والتعنت والاستهزاء . - سؤال المعجزات ، وطلب خوارق العادات عناداً وتعنتاً ، أو إزعاجاً وإرباكاً ، كما كان يفعل المشركون وأهل الكتاب . - السؤال عن الأغاليط : روى أحمد وأبو داود : عن معاوية رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات ، وهي المسائل التي يغالَط بها العلماء ليزِلّوا فيها ، فيهيج بذلك شر وفتنة ، وإنما نهى عنها لأنها غير نافعة في الدين . - السؤال عما لا يحتاج إليه ، وليس في الجواب عنه فائدة عملية ، وربما كان في الجواب ما يسوء السائل . - السؤال عما سكت عنه الشرع من الحلال والحرام ، ولم يبين فيه طلباً أو نهياً ، فإن السؤال عنه ربما كان سبباً للتكليف به مع التشديد فيه ، فيترتب على ذلك وقوع المسلمين في حرج ومشقة ، كان السائل سبباً فيها ، وهذا في زمن نزول الوحي . والذي يتعين على المسلم أن يهتم به ويعتني هو : أن يبحث عما جاء عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه ، فإن كان من الأمور العلمية صدق به واعتقده ، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه، فمن فعل ذلك حصل السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة . التحذير من الاختلاف والحث على الوحدة والاتفاق : لقد وصف الله تعالى الجماعة المسلمة والفئة المؤمنة بأنها أُمَّة واحدة . فقال سبحانه : { إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِي { [ الأنبياء : 92 ] فينبغي على المسلمين أن يحرصوا على هذه الوحدة ، حتى يكونوا قوة متماسكة أمام قوى الشر والبغي والكفر المتكاثرة . ولقد حذرنا الله تعالى ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من الاختلاف ، وكذلك يقرر القرآن أن هذا شأن الذين كفروا من أهل الكتاب ، قال تعالى : } وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ { [ آل عمران : 105 ] إن من أهم الأسباب التي تفرق الأمة وتشتت شملها أن يُفْتَحَ عليها باب الجدل في العلم والمِراء في الدين ، فتختلف في الأساس . والبلية كل البلية أن يكون الحامل على الاختلاف في الدين المصالح والأهواء ، و العناد و البغي ، ولذا نجد كتاب الله تعالى يخرج أمثال هؤلاء الناس الذين يُثيرون الخلاف في الدين ويريدون أن يجعلوا المسلمين شِيَعاً وفرقاً وأحزاباً ، نجده يخرجهم من دائرة الإسلام ، ويبرئ منهم نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول : } إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ { [الأنعام : 159] والخطر إنما يكمن في هذا النوع من الاختلاف ، الذي لا يحتكم إلى برهان ولا ينصاع إلى حجة ، وهذا الاختلاف هو الذي كان سبب هلاك الأمم ، وإليه يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : )فإنما أهلكَ الذين من قبلكم كثرةَ مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ( صحيح مسلم أما الخلاف الناشئ عن دليل ، ويستند إلى أصل ، فليس هو المقصود في الباب ، لأنه خلاف في الفروع وليس في الأصول ، وخلاف ليس من شأنه أن يحدث الفرقة والشتات في صفوف الأمة ، بل هو عنوان مرونة التشريع وحرية الرأي فيه ضمن قواعده وأسسه |
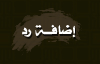 |
|
|
 |